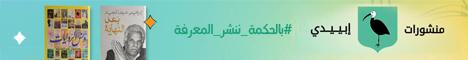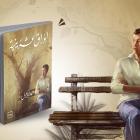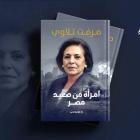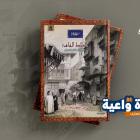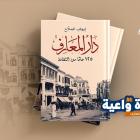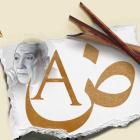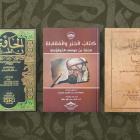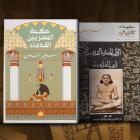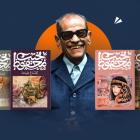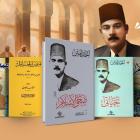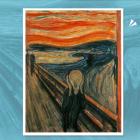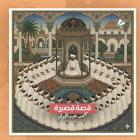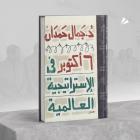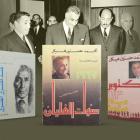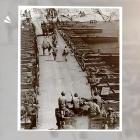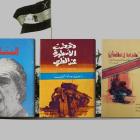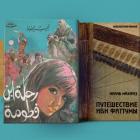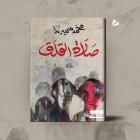معرفة
محمود علي مكي والإرث العظيم
في ذكرى رحيله.. نتأمل إرث العلامة محمود مكي، شيخ الدراسات الأندلسية، الذي جمع بين دقّة المحقق وعمق المفكر، فخلّد اسمه في ذاكرة الثقافة العربية والإسبانية
 الأستاذ الدكتور محمود علي مكي وعدد من أغلفة أعماله
الأستاذ الدكتور محمود علي مكي وعدد من أغلفة أعماله
للاطلاع على الجزء الأول
إرث العلامة الاستثنائي
قبل اثني عشر عامًا من هذه الأيام، وفي هدوء تام عاش به طيلة حياته، وصمتٍ اعتدناه وتعودنا عليه عند رحيل الكبار، رحل عن عالمنا الأستاذ الدكتور محمود علي مكي (1929-2013)؛ العلّامة الاستثنائي في الدراسات العربية الإسبانية، المحقّق الجهبذ، والمترجم البارع، والدارس المدقق، شيخ شيوخ الدراسات الأندلسية في مصر والعالم العربي والجامعات العالمية، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بالعاصمة الإسبانية مدريد، يوم الأربعاء الموافق السابع من أغسطس 2013.
عاش الدكتور مكي حياته في هدوء وتبتّل وإخلاص شديد للمعرفة، وكان أحد الموسوعيين الكبار، ممن تعددت إسهاماتهم العلمية في مجالات مختلفة ومتباينة ومتعددة؛ درسًا وتدريسًا وترجمةً وتأليفًا وتحقيقًا، وربما احتاج كل إسهام أصيل من إسهاماته إلى ما يفيض عن حجم مقال في أي مطبوعة كانت (وإن كان هذا لا يمنع من الإشارة إليها، والإلماع إلى أبرزها تأليفًا وتحقيقًا وترجمة، وهو ما سنعرض له في فقرة تالية)، هذا عدا عشرات البحوث والمقالات والدراسات التي نشرها في مختلف الصحف والمجلات والدوريات العلمية في مصر والعالم العربي، وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، باللغتين العربية والإسبانية (ربما تصل إلى المئات في ظل عدم وجود حصر دقيق أو ببليوغرافيا كاملة يمكن الرجوع إليها).
تنوع إنتاجه وغزارته
طوال ما يزيد على عشر سنوات صاحبت فيها سيرة الدكتور محمود علي مكي، وتتبعت إنتاجه الذي أذهلني بقدر ما أمتعني وأفادني، لفتني بشدة تنوّع هذا الإنتاج وغزارته، بالإضافة إلى جمعه بين مجالات معرفية دقيقة عدة يصعب الجمع بينها.
ففضلًا عن تخصّصه الدقيق في الثقافة الأندلسية (لغةً وأدبًا وتاريخًا وحضارةً)، واطلاعه الواسع على الثقافة الإسبانية الحديثة والمعاصرة، وآداب أمريكا اللاتينية بشكل عام، كان الدكتور مكي أحد العلماء القلائل المتمكّنين والراسخين في الدراسات الإسلامية، وعلوم القرآن، والحديث، والفكر الإسلامي قديمه وحديثه، إضافة إلى مساهماته الأصيلة والجادة في الأدب المقارن، والنقد الأدبي، وتاريخ الأدب، وعلوم اللغة، والنحو، والبلاغة.
وكان مدهشًا ومثيرًا للتعجب والإعجاب معًا أن أول ما قرأتُ له دراستين مرجعيتين رائعتين لا أنساهما:
أولاهما؛ دراسته المستوعبة المحيطة عن «علوم القرآن في الأندلس»، واكتشفت فيما بعد أنه قد اختط سبيل الدراسة الموضوعية فيما يخص الثقافة الأندلسية؛ إذ يفرد لكل موضوع بذاته دراسة تكاد لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أو تدخل في دائرته، أو تمت إليه بصلة. على سبيل المثال، سأقرأ له لاحقًا في هذا المسار التأليفي المميز: «التشيع في الأندلس»، «كتابة السيرة النبوية في الأندلس»، «الدراسات اللغوية والنحوية في الأندلس».. إلخ.
أما الدراسة الثانية؛ فكانت مقدمته التفصيلية لرواية جورجي زيدان التاريخية عن «فتح الأندلس» الصادرة عن (دار الهلال)، وقد استنّت الدار في ثمانينيات القرن الماضي سنة حميدة للغاية لم تُستأنف وتتواصل بعد ذلك للأسف، وهي أنها تُعنى بنشر أعمال صاحبها ومؤسسها الرائد النهضوي جورجي زيدان (1861-1914) بعناية وتقديم أحد كبار الأساتذة المتخصصين في الأدب والثقافة العربية والإسلامية، فكان إعادة نشر كتابه المرجعي «تاريخ آداب اللغة العربية» (في أربعة أجزاء)، بعناية ودراسة وتقديم الدكتور شوقي ضيف، وكتابه «تاريخ التمدن الإسلامي» (في خمسة أجزاء) بعناية وتقديم ودراسة ومراجعة الدكتور حسين مؤنس.. وهكذا.
فيض القلم
وفي العموم، فقد فتحت لي كلتا الدراستين آفاقًا من المعرفة وحبًا واستمتاعًا حقيقيًا بالدرس التاريخي للأدب، والغوص في نصوصه والبحث عن مظانّه. وكان كتابه الرائع المكتوب بمداد المحبة والأشواق والتوق إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعنوان «المدائح النبوية» أحد الكتب التي تلازمني، أعاود قراءته وأعود إليه مرارًا، لحلاوته وجمال مادته واختياراته العذبة الرائقة من عيون الشعر والقصائد التي تغنت بسيرة الرسول الكريم وبمدحه (صلى الله عليه وسلم). وكان الكتاب –على صغر حجمه (لم يتجاوز 180 صفحة من القطع الأصغر من المتوسط)– شاملًا مستوعبًا لأهم وأبرز شعراء المديح النبوي من عصر النبي ومن الصحابة إلى القرون الحديثة.
من شدة تقديري وإعجابي بنتاج أستاذي الجليل؛ فاض القلم بأسطر ما زلت أحتفظ بها في أوراقي الشخصية لحسن الحظ! وقد آن أوان وضعها في موضعها من هذه المقالات عن أستاذي الجليل.. كتبت في بعض أوراقي القديمة:
«وإذا كانت كلمة "عالم" قد وصلت إلى درجة من الابتذال والاعتيادية لكثرة ما أُطلقت على من لا صلة لهم بالعلم من قريب أو بعيد، وفقدت معناها في كثير من الدوائر التي تتصل –افتراضًا– بالعلم ومناهجه وحقوله المعرفية، فإنها تنطبق حرفيًا، مبنى ومعنى، على الأستاذ الكبير الدكتور محمود علي مكي، الذي كان «عالمًا جليلًا» بكل ما تعنيه الكلمة وتحمله حروفها. كان رجلًا شجاعًا ومفكرًا من الوزن الثقيل، وكان قادرًا على تقديم اجتهادات ذات تأصيل وعمق في المعالجة والمقاربة المنهجية. لقد أفاد الإسلام بوجهه الفكري المتسامح والمحاور والمدافع عن القيم والعقائد الإسلامية في مواجهة بعض الدوائر التي تتربص بالديانة والثقافة الإسلاميتين بالخارج».
كان هذا تعليقًا موجزًا على بعض ما قرأت من أعمال أولى للدكتور مكي أشرت إليها في الفقرة السابقة، وكنت أدوّن بعض الملاحظات على كتابٍ له هنا أو تحقيقٍ له هناك، ثم صاحبته بعد ذلك في رحلة طويلة ممتدة اطّلعت خلالها على معظم إنتاجه الذي يصعب حصره ما بين تأليف وتحقيق وترجمة، واشتراك في مؤلفات جماعية، عدا دراساته المبثوثة في بطون الدوريات والمجلات العلمية التي تنتظر من ينقّب عنها ويجمعها في مجلدات بين أيدي الدارسين والباحثين، وهو ما نعكف عليه الآن بكل حب وشغف واحترام في دار المعارف.
الابتعاث إلى إسبانيا
تخرج الدكتور محمود علي مكي في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة عام 1949، وكان في العشرين من عمره. يشهد له الجميع أساتذة وطلابًا وزملاء دفعته بأنه كان «نابغة» دفعته بكل ما تعنيه الكلمة؛ بارزًا ومتفوقًا بصورة تعجز أقرانه عن منافسته أو مجاراته في هذا التفوق المعجز. حباه الله «ذاكرة» صارت مضرب الأمثال، وحباه استعدادًا فطريًا دعمه بالاكتساب والدربة والدأب على تعلم اللغات واكتساب مهاراتها، وقد أطّر ذلك كله بثقافة واسعة عريضة عميقة صارت بدورها مضرب الأمثال! ثقافته العربية التراثية الأصيلة كانت مذهلة، واطلاعه على الآداب المعاصرة العربية منها وغير العربية كذلك كان واسعًا ومستوعبًا ومحيطًا.
وقد انتمى الدكتور مكي إلى ذلك الجيل الذي تتلمذ بشكل مباشر على طه حسين، وعلى الرعيل الأول من تلاميذه الذين تخرجوا على يديه، وقد تشرب منه أسس وأبجديات «المنهج التاريخي» في الدرس الأدبي والمقارن، وطبّقه في كثير من دراساته وأبحاثه على الأدب الأندلسي وغيره من حقول الدراسة الأدبية والتاريخية. وكتبه وأبحاثه كمترجماته وتحقيقاته تضعه في مكانة استثنائية وفريدة في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة.
ثم عندما أتيح له الابتعاث إلى إسبانيا (ابتُعث عام 1950) للحصول على الدكتوراه بهر الإسبان (وغير الإسبان!) بإجادته للإسبانية وطلاقته المدهشة، وتفوّقه ونبوغه، وقد حصل بالفعل على الدرجة الرفيعة عام 1955 بعد خمس سنوات فقط من سفره إلى مدريد، عن أطروحته التي كتبها بالإسبانية بعنوان «التيارات الثقافية المشرقية وأثرها في تكوين الثقافة الأندلسية حتى نهاية القرن الرابع الهجري». ولأنه كتبها بالإسبانية؛ نشرها كذلك بالإسبانية عام 1967م، وأفاد منها –بعد ذلك– في عديد كتاباته وأبحاثه الممتازة عن ثقافة الأندلس وحضارته، كما سنبين تفصيلًا في فقرات تالية.
عشر سنوات قضاها هناك الدكتور مكي (1954-1964) أنشأته إنسانًا جديدًا، وتركت في نفسه أثرًا بالغًا ومقيمًا وراسخًا. عن تلك الفترة وأثرها في نفسه وروحه يقول الدكتور مكي في واحد من الحوارات التي أُجريت معه:
«إن وجودنا على أرض الأندلس هو الذي سمح لنا باكتشاف تراثها اكتشافًا حقيقيًا، وقد بدأنا منذ سنتنا الأولى هناك بإعداد برنامج طويل الأمد لزيارة كل مكان في الأندلس، بما في ذلك البلاد الشمالية التي وجدت فيها ممالك وإمارات كانت تناهض الأندلس الإسلامية، وقد ساعدنا ذلك على تكوين صورة مختلفة تمامًا عمّا نقرأه. بالإضافة إلى هذا بدأنا باعتماد المصادر المكتوبة باللغة الإسبانية، والتي تتضمن معلومات جديدة ومهمة لا يغني عنها ما نقرأه في المصادر العربية. لقد كانت تجربة على درجة كبيرة من الأهمية، وذخيرة نفعتنا بعد ذلك في كل ما أنجزناه، وهو قليل من كثير مما يجب أن يُبذل في سبيل التعريف بالحضارة الإسلامية في الأندلس».
(وللحديث بقية).